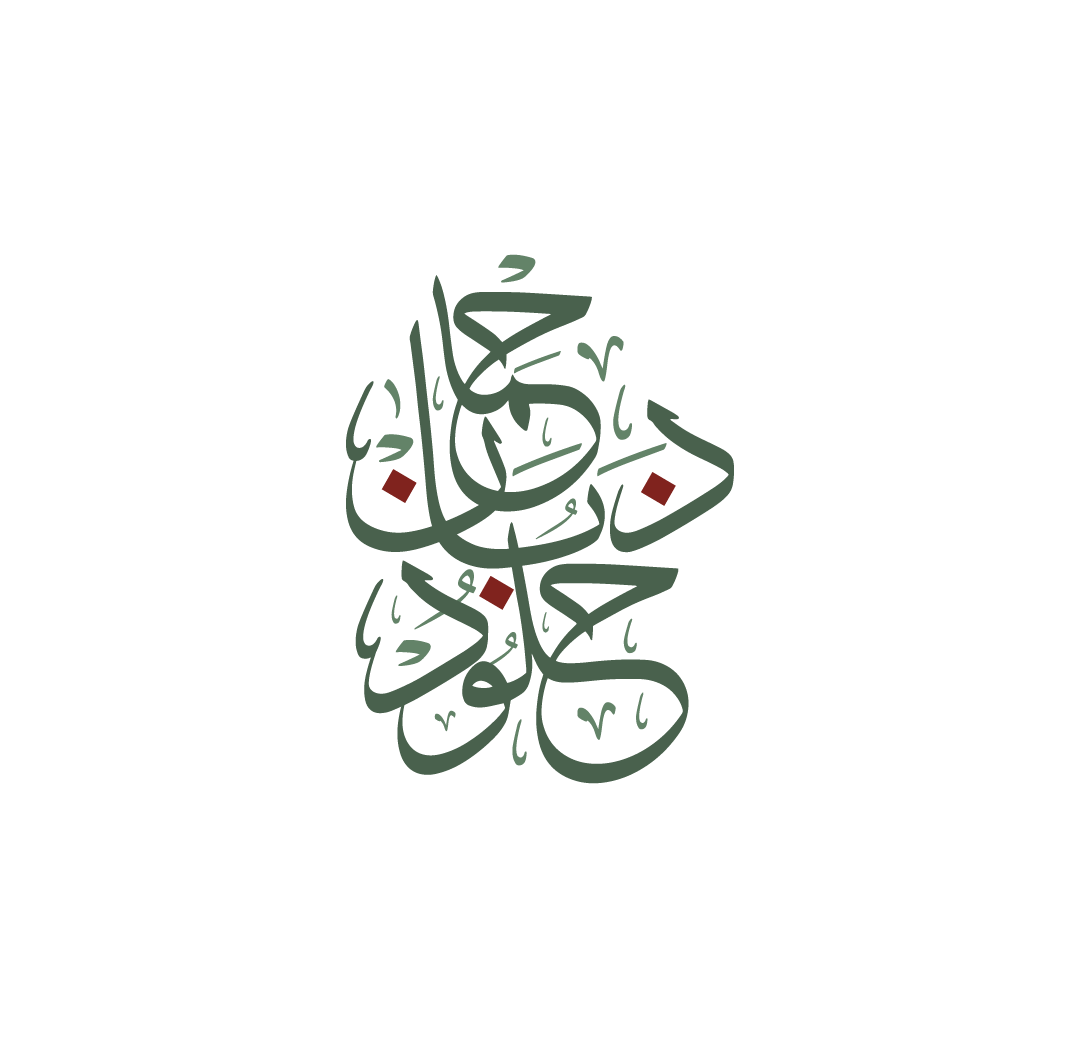طوال عطلة نهاية الأسبوع، ظلّت فكرة “الحساسية تجاه اللغة” ترافقني، تدفعني للتأمل في سبب انزعاجي من بعض التعابير التي تبدو عادية للآخرين. هل هو مجرد ذوق شخصي، أم انعكاس لجزء أصيل من الاحترافية التي أؤمن بها؟
أدركت أن الأمر لا يتعلق بنيّة المتحدث، بل بوقع الكلمة نفسه على ثقافة الفرد وحساسيته اللغوية؛ فبعض الألفاظ مهما كانت شائعة تترك في الذهن ظلالًا غير محببة، وتخلق فجوة بين ما يُراد قوله وما يصل فعلًا. وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال لا يفارقني: متى تسللت هذه اللغة الدارجة إلى المكاتب؟
حين نتعلم أي لغة نجد تباينًا واضحًا بين التعابير اليومية المستخدمة في الأحاديث غير الرسمية، وبين اللغة المصقولة التي تُعتمد في المراسلات والعروض والاجتماعات. في الحياة اليومية (قد) يُسمح للعفوية والمبالغة والتراخي في اختيار الكلمات، بينما في بيئة العمل تُصاغ الجمل بعناية لتكون دقيقة وواضحة.
لم يكن انتقال هذه اللغة مقصودًا إلا أنه مع الوقت صار سماع عبارات عامية في مواقف مهنية أمرًا مألوفًا للبعض، ومربكًا أو غير مريح للبعض الآخر.
المشهد الأول:
أثناء تقديم تغذية راجعة قال أحدهم “الملف مبني بطريقة تسليكية”!
تحمل الجملة انطباعًا مبهمًا تسقط فيه كل عناصر التقييم المهني والتوجيه الاحترافي، من معايير واضحة أو ملاحظات بنّاءة.
المشهد الثاني:
أثناء مراجعة قائمة أولويات، طُرح سبب واضح لاستبعاد وتجاهل أحد الملفات، لكن القرار جاء بعبارة “اسحب عليه”!
ورغم وجاهة المبرر، فإن وقع الكلمة ليس ملائمًا للسياق المهني.
المشهد الثالث:
في جلسة عصف ذهني وخلال مرحلة تقييم الأفكار، ذُكر تعبير عامي مخجل (لا أعرف متى صار مقبولًا) ليصف أننا استهلكنا الفكرة المطروحة!
تحمل الكلمة صورة ذهنية غير ملائمة للسياق المهني.
أذكر أني طرحت هذا النقاش حول المشاهد الثلاث بين مجموعة من الزميلات، فقالت لي إحداهن: “خلود، يعني أنتِ لا تستعملين هذه الكلمات؟” والحقيقة أنني فعلًا لا أستعملها. ومع ذلك، فإن الأمر ليس مجرد نفور شخصي، بل قبول أي كلمة أو رفضها يُعزى لثلاثة أبعاد أساسية: أصلها (من أين جاءت؟ هل هي دخيلة، دارجة محلية، أم ذات خلفية ثقافية معينة؟)، معناها المباشر (ما الذي تعنيه حرفيًا في السياق اللغوي؟)، ودلالتها (ما الذي تستحضره في الذهن من صور وانطباعات). هذه الأبعاد تحدد إن كانت الكلمة تضيف قوة ووضوحًا للرسالة، أم أنها تترك أثرًا سلبيًا، وتشوّه السياق المهني الذي قيلت فيه.
الكلمات ليست مجرد أدوات تواصل، بل هي مكونات أساسية لثقافة الفرد وصورته أمام نفسه والآخرين.
اللغة المهنية أكثر من ألفاظ رسمية
لا تعني اللغة المهنية فقط استبدال العامية بالفصحى أو الكلمات البسيطة بكلمات تخصصية معقدة، إنما هي منظومة قيم تنعكس في اختيار الكلمات، نبرة الصوت، وبنية الجملة، بما يحقق:
- الوضوح: نقل الرسالة دون غموض أو التباس.
- الملاءمة: مطابقة اللغة للسياق والهدف والجمهور.
- الحياد: تجنب التحيز، والسخرية، واللغة العاطفية المفرطة.
- الاحترافية: إظهار الجدية والاحترام، حتى في أبسط التعليقات.
📖 يقودنا هذا إلى نظرية التوقع اللغوي Language Expectancy Theory التي طوّرتها الباحثة جوديث بوروغون (Judee Burgoon)، أن الناس يدخلون أي موقف تواصلي وهم يحملون توقعات مسبقة حول نوعية اللغة التي ينبغي أن تُستخدم فيه، استنادًا إلى السياق، والعلاقات، والمعايير الثقافية السائدة.
فعندما يلتزم المتحدث بهذه التوقعات، تُستقبل رسالته بسلاسة، ويُركَّز على مضمونها، أما إذا انحرفت اللغة عن المتوقع — حتى من دون قصد — فقد يتحول انتباه المستمع من الفكرة إلى الكلمة ذاتها، بما يؤثر على فهم الرسالة أو على صورة المتحدث.
في بيئة العمل، تصبح هذه الفكرة أكثر وضوحًا لأن أي تعبير مبهم أو عامي في اجتماع أو تقرير أو خطاب، قد يغيّر مسار الحوار ويضعف أثره. وهنا لا نتحدث فقط عن الموقف نفسه، بل عن الخلفية اللغوية والتي تحدد كيف يختار المتحدث مفرداته، وكيف يتصور ما هو مناسب أو غير مناسب، وهذا يأخذنا للحديث عن الثقافة اللغوية للفرد، وكيف تتشكل، ولماذا هي أساس ضبط اللغة المهنية.
الثقافة اللغوية للفرد
أجد نفسي دائمًا أقيّم الكلمات التي أسمعها، ويستغرب من حولي رفضي لبعض العبارات الدارجة وعدم تقبلي لها وأظنني البعض أبالغ، وحين تأملت الأمر، تذكرت أن جذور هذه الحساسية تعود إلى تربية والديّ؛ فقد كانا صارمين تجاه الألفاظ، وأي كلمة غريبة كنت أنطق بها في صغري كانا يبادران بالسؤال: “من أين تعلمتها؟” وهذا جعلني أتفهم حساسيتي تجاه اللغة، فلكل فرد رصيد لغوي يتشكل عبر سنوات التنشئة والتربية، والتعليم، والبيئة الاجتماعية، والخبرة المهنية. هذه الثقافة تحدد: كيف يختار كلماته؟ ومدى حساسيته؟ وهل يلتقط الانحرافات أو الكلمات غير الملائمة بسرعة؟
ولتوضيح مكونات هذه الثقافة، يمكن تقسيمها إلى أربعة أبعاد رئيسية:
- المخزون اللغوي: تنوع الكلمات التي يعرفها الفرد ويستطيع استخدامها.
- الوعي بالسياق: القدرة على تعديل اللغة بما يناسب الموقف.
- التأثير الاجتماعي: إدراك أثر الكلمة على الفرد والمجموعة.
- التكيّف الثقافي: معرفة ما يصلح في بيئات عمل مختلفة.
هذه القدرة ليست عشوائية، بل تتسق مع ما يُعرف بـ Cooperative Principle الذي وضعه بول غرايس، حيث تقوم فعالية التواصل على الالتزام بأربعة مبادئ: الكمية (قول ما يكفي ولا يزيد)، الجودة (قول ما هو صحيح ومدعوم)، الملاءمة (ارتباط الكلام بالموضوع والسياق)، والوضوح (إيصال الفكرة بلا غموض) وبقدر ما تكون الثقافة اللغوية للفرد ناضجة، بقدر ما يلتزم بهذه المبادئ تلقائيًا دون جهد واعٍ، فيحافظ على الاحترافية ويعزز أثر رسالته.
الحساسية تجاه اللغة
وبالرغم من أن الثقافة اللغوية ومبادئ التواصل الفعّال يمكن أن يمتلكها أي شخص، إلا أن الملاحظات الميدانية وبعض الدراسات تشير إلى أن هناك فئة من الأفراد تُظهر حساسية أكبر تجاه اختيار الكلمات، وتلتقط الانحرافات اللغوية بسرعة.
وغالبًا ما تبرز هذه الحساسية لدى العديد من النساء، ليس كقاعدة عامة، بل كميل إحصائي متأثر بالتربية والخبرة والسياق الثقافي.
هذه الحساسية تجعل من صاحبها بمثابة حارس على اللغة، يذكّر الآخرين بمعايير الأناقة اللغوية ويحمي المجموعة من المفردات التي قد تضعف صورتها.
📊 دراسة Leaper & Robnett (2011)
أجرت الباحثتان تحليلًا تلويًا (Meta-analysis) شمل عشرات الدراسات حول الفروق اللغوية وركزت على ما يُسمى اللغة التحوطية أو الحذرة (Tentative Language)، التي تتضمن مؤشرات لغوية تقلّل من حدة التصريح، مثل: «قد»، «ربما»، «أليس كذلك؟»، أو «قد أكون مخطئة، لكن…».
أظهرت النتائج أن النساء في المتوسط، يستخدمن هذا النمط أكثر قليلًا من الرجال، خاصة في المواقف التي تتطلب حساسية اجتماعية أو رغبة في الحفاظ على الانسجام.
📚 Deborah Tannen – Difference Model
تفسر تانن هذا الميل ضمن إطارين:
- Rapport Style – أسلوب بناء العلاقة، ويميل إليه النساء في المتوسط، حيث يركز على الحفاظ على الروابط وتهيئة بيئة آمنة للحوار، مع تجنب الصدام.
- Report Style – أسلوب نقل المعلومة، ويميل إليه الرجال في المتوسط، حيث يركز على الكفاءة ونقل الحقائق واتخاذ القرارات مباشرة.
وتؤكد تانن أن هذه ليست قواعد حتمية، بل ميول عامة تتأثر بالسياق، والخبرة، والدور الوظيفي. في بيئة العمل، يتميز rapport style بقدرته على ضبط النبرة ومنع الانزلاقات اللغوية، بينما يضمن report style الحسم والوضوح عند اتخاذ القرارات.
ومع ذلك، فليس كل النساء يتسمْن بهذه الحساسية اللغوية، ولا كل الرجال يفتقرون إليها، وذلك يتوقف على عدة عوامل:
- الخلفية الثقافية: ما يُعتبر لائقًا أو غير لائق يختلف من بيئة لأخرى.
- الخبرة والتجربة: من اعتاد بيئة لغوية منضبطة، تصبح حساسيته أعلى.
- السمات الشخصية: وفق Big Five، فإن ارتفاع الضمير الحي والتوافق الاجتماعي يعزز الحذر في اختيار الكلمات والانتباه لتأثيرها.
هذه العوامل تفسر لماذا قد يلتقط شخص ما عبارة غير مناسبة فورًا، بينما تمر على آخر دون أن يلحظها.
لماذا تعتبر هذه الحساسية قيمة مضافة؟
في الواقع العملي، الشخص الذي يلتقط الكلمات غير الملائمة، يقوم بدور أشبه بـ “حارس اللغة”:
- ينتبه فورًا إذا انحرفت الكلمة عن السياق المتوقع (Language Expectancy Theory).
- يقيّم أثرها على الجو العام، حتى لو كان مضمون الرسالة صحيحًا.
- يقترح بدائل مهنية تحفظ المعنى وتراعي الأثر.
هذه الحساسية ليست رفاهية، بل أداة استراتيجية تحمي المناخ المهني، فهي تضمن أن يظل التركيز على الفكرة لا على اللفظ، وتمنع أن يصبح اجتماع كامل أسير كلمة عابرة. ومن زاوية أخرى، فإن وجود شخص في الفريق — يتمتع بحساسية لغوية عالية ويلتزم بضبط المفردات — يفرض بطبيعته مستوى أعلى من التقنين في الحوار. هذا الحضور قد يغيّر إيقاع النقاشات، فيجعل البعض أكثر انتقائية في كلماتهم أو أقل عفوية في التعبير وبالنسبة للبعض قد يُنظر إلى هذا التغيير على أنه تضييق على الأسلوب المعتاد، خاصة إذا كانوا يفضلون لغة أقل رسمية.
الحارس اللغوي الناجح يعرف متى يستخدم rapport style لخلق بيئة آمنة وتشاركية، ومتى يتحول إلى report style لحسم القرار.
- في بدايات الاجتماع: لغة تشاركية، عبارات تفهم، أسئلة استيضاح.
- عند الإقفال: لغة تقريرية واضحة، تحديد مهام، ومواعيد نهائية.
هذا التوازن هو ما يحوّل الحساسية اللغوية من مجرد رد فعل، إلى مهارة قيادية تبني ثقافة لغوية واعية في الفريق، تحافظ على الاحترافية دون أن تخنق الإبداع أو العفوية.
من الفرد إلى المؤسسة: بناء ثقافة لغوية
عندما تتحول هذه الحساسية إلى جزء من ثقافة المؤسسة، تتحقق عدة فوائد:
- انضباط التواصل الداخلي.
- تعزيز صورة العلامة التجارية أمام العملاء.
- تقليل المخاطر المرتبطة بسوء الفهم أو التفسيرات السلبية.
أما عن الخطوات العملية لبناء هذه الثقافة:
- وضع معايير واضحة للغة المهنية في الأدلة الداخلية.
- تدريب الفرق على بدائل العبارات غير المهنية.
- التغذية الراجعة الفورية عند حدوث انحراف لغوي.
- التزام القادة باللغة المهنية باستمرار وهذه هي القدوة.
أخيرًا
أستطيع القول أني فهمت اليوم لماذا يظن البعض أنني “أتفلسف” أو أعقّد المصطلحات، بينما الحقيقة أنني أتحدث بالمخزون اللغوي والثقافي الذي نشأت عليه، وما أراه جزءًا أساسيًا من الاحترافية: استخدام لغة مهنية منضبطة.
الأمر ليس استعراضًا لغويًا، بل وعي بأن الكلمة تحمل صورة ذهنية وأثرًا ثقافيًا، وأن الانزلاق إلى التعبيرات العامية أو العبارات المبتذلة قد يضعف الرسالة مهما كانت الفكرة قوية.
اللغة المهنية ليست مجرد صياغة جمل مهذبة، بل هي أداة استراتيجية لبناء الثقة، وضبط بيئة العمل، وحماية صورة المؤسسة.
وحين يمتلك الأفراد حساسية لغوية عالية، فإنهم يصبحون حراسًا لهذه الأداة، يحافظون على قوتها ويحمونها من التآكل، ومن يقوم بهذا الدور يضيف قيمة تتجاوز مجرد ضبط المفردات، فهو يساهم في صياغة ثقافة لغوية تبقى آثارها في كل اجتماع، وكل رسالة وانطباع يخرج به الآخرون عن الفريق.